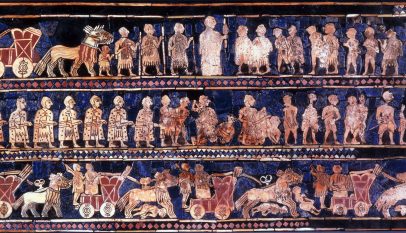أبو إلياس – طريق الحقيقة رقم 9
طريق الحقيقة رقم -9-
الإنسان والأزمة النفسية:
1-الإنسان وعالم اليوم.
2- لماذا يعيش إنساننا في أزمة نفسية ؟
3- الفلسفة كعامل مؤثر في الأزمة النفسية في سياقها التاريخي.
4- نقد طريق الحقيقة للفلسفات السابقة وطريق الحل
5- القضية الكردية ودورها في حل الأزمة النفسية لأبناء الشعوب الأربعة.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1ً- الإنسان وعالم اليوم:
الإنسان أكبر قيمة في الوجود . وفي عالم اليوم تحول إلى أرخص قيمة لقد بات الإنسان يعيش مع بداية القرن الحادي والعشرين في أزمة نفسية حادة. ويلاحظ أنه كلما تقدمت الحضارة زادت أزمته النفسية. فكلما كشف الإنسان أسرار المادة. وأبدع وسائل تكنيكية وحاجات ترفيهية جديدة كلما تراجعت راحته النفسية إلى الوراء لقد كان الإنسان مرتاح البال والنفس عندما كانت تقنيته وحاجاته الترفيهية بسيطة وبدائية. وبالرغم من أنه كان يبذل جهداً كبيراً في نشاطاته وصراعه مع الطبيعة ولكنه كان مرتاح النفس والبال. إننا نرى اليوم أن كل الجهد الفكري والعلمي مكرس لكشف مزيد من أسرار المادة. وتقنيات جديدة . ولكن لماذا تزداد أزمة الإنسان النفسية ؟ إن جميع شعوب العالم الثالث المتخلف مشغول بنسبة مائة بالمائة في الصراع السياسي. وكأن العامل السياسي فانوس سحري يحل به كل مشاكل الإنسان ويؤمن حاجاته.
والسياسة ليست سوى التربع على كرسي الحكم مهمته تنظيم شؤون الناس والمراقبة. تماماً كشرطي السير الذي ينظم مرور السيارات في الاتجاهات.
ترى لماذا تحول كرسي السياسة إلى صنم للعبادة ؟
هل خلق الإنسان ليكون في خدمة السياسة ؟ أم خلقت السياسة لتكون في خدمة الإنسان ؟
مع مرور كل يوم تزداد مشاكلنا النفسية بحيث تشمل المجتمع بكامله بين الزوج وزوجته وبين الأب وأولاده . وبين الجار وجاره وبين الأمم. إن بخار السياسة قد أفسد عقول الناسِ بالكامل لم يعد يرى الناس أو يعرف من هذه الدنيا سوى اللون السياسي في كل يوم يجتمع الملايين من الناس يشترون ويبيعون ويمارسون نشاطهم في الزراعة والتجارة والمدرسة والوظيفة ولكن لا أحد يفهم الآخر ترى أي علم يساعدنا على فهم بعضنا البعض والتعامل مع بعضنا كبشر . ويساعدنا على حل مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأسروية . ويساعدنا على حل أزمتنا النفسية التي نعيشها ؟ تلك هي مهمة علم الفلسفة .
2ً- لماذا يعيش إنساننا الأزمة النفسية ؟
لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بعد أن نطلع على علم الفلسفة في السياق التاريخي والمراحل التي مر بها وكيف تعامل الإنسان معها عبر التاريخ ويترك الحكم للقارئ لكي يختار الفلسفة التي يراها مناسبة له في تعامله مع الواقع.
3ً- الفلسفة كعامل مؤثر في الأزمة النفسية خلال مراحل التاريخ :
كون الفلسفة علم اجتماعي اتخذ في سياقه التاريخي طابعاً إيديولوجيا فكان في كل مرحلة يعبر عن وجهة نظر طبقة اجتماعية معينة تحميها ويدافع عن مصلحتها الطبقية وهكذا انقسمت الفلسفة إلى مراحل تاريخية وقسمها المفكرون إلى المراحل التالية:
1- الطبقة العبودية التقسيم الاجتماعي سيد عبد الحكم مطلق وراثي إلهي
2- الطبقة الإقطاعية التقسيم الاجتماعي إقطاعي فلاح الحكم مطلق وراثي
3-الطبقة البرجوازية التقسيم الاجتماعي برجوازي بروليتاري الحكم تناوب سلطة
4- الطبقة البروليتارية لا طبقي الحكم بيروقراطي تعيين دائمي من السلطة إلى القبر.
ولدراسة الفلسفة كعامل مشترك بين هذه الطبقات وكيف نظرت كل طبقة بفلسفتها إلى الواقع الاجتماعي
والطبيعة والفكر وطرحت البديل لا بد من تقسيم هذه المراحل .
1-نقد الفلسفة الإقطاعية للفلسفة العبودية وطرح البديل ومفهوم المساواة
2- نقد الفلسفة البرجوازية للفلسفة الإقطاعية ومفهوم المساواة وطرح البديل
3- نقد الفلسفة البروليتارية للفلسفة البرجوازية ومفهوم المساواة وطرح البديل
أ- الطبقة الإقطاعية وفلسفتها . الدين ومفهوم المساواة
لقد اعتمدت الطبقية الإقطاعية على الفلسفة الدينية ومرجعياتها الكتب المقدسة السماوية .. تقول الفلسفة الدينية في مفهوم المساواة بين الناس((مساواة الناس أمام الله)) إن الناس متساوون أمام الله لا فرق بين غني وفقير وأسود وأبيض إلا بالتقوى وهذا يعني ممارسة الطقوس والعبادات مع بعضهم البعض بشكل متساوي. أما وجهة نظر الدين للناحية الطبقية هي (( الله مقسم الأرزاق)) فإذا كان هناك أغنياء وفقراء لأن الله أراد ذلك وعلى الطرفين أن يكونا راضيين بما قسم لهم أما بخصوص الناتج والمنتوج فكل دين له طريقته الخاصة للتصرف والتوزيع فمثلاً الإسلام يتصرف بالناتج والمنتوج حسب طريق الزكاة . أما تنظيم السلوك الأخلاقي فيحدد وفق قواعد وقوانين جزائية نصوصها واردة في الكتب المقدسة وانقسم الجزاء إلى دنيوي وسماوي فالمحاسبة الدنيوية تقوم بها السلطة السياسية الحاكمة بأمر الله والمحاسبة السماوية في الآخرة .
حيث يقف الإنسان أمام ربه وهي الدنيا الخالدة . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . وكذلك حدد الله سبحانه وتعالى ونظم علاقة الرجل بالمرأة. أما وجهة نظر الفلسفية الدينية للسياسة ((أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم)) وأولي الأمر يتم بالتعيين يورثون السلطة لأبنائهم. وكان من الطبيعي أن يتمتعوا بكافة الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية لقد كانت وجهة نظر الفلسفة الإقطاعية للنظام الاجتماعي كالآتي : لا يمكن أن يقوم نظام اجتماعي إلا بالإرغام وظنوا بأن الجماهير غير قادرة على مراعاة قواعد السلوك والأخلاق إلا في ظل الخوف والعقاب وتحت سيطرة وحكم السيد الواقف على رأسها وإذا لم يكن هناك قسر وإرغام ولا سيد واقف على رأسها ستقع الجماهير في حالة من الخمول واللامبالاة والتوحش وبذلك يكون من المستحيل خلق أي شكل من أشكال الحياة المشتركة بين الناس في المجتمع- والفلسفة الدينية تقول: يجب أن يحكم العالم نظام رباني اجتماعي واحد بني لمرة واحدة وللأبد. والمؤمنون بالفلسفة الدينية ينظرون للواقع الاجتماعي ويحللونه بمقياس الماضي ويقولون إذا كانت هناك مؤسسات وقواعد اجتماعية ونظم سياسية غير صالحة واحتجاج جماهيري. فسبب ذلك هو التشويه الذي لحق بالقصد الإلهي الأولي نتيجة ظلم الظالمين وجهل المظلومين فإذا كان الناس يعانون من العذاب فذلك ليس بسبب تلك المتغيرات المادية التي حصلت في السياق التاريخي للممارسة الاجتماعية التاريخية. ونتيجة الثورة العلمية التقنية. بل هي بسبب تلك المتغيرات التي طرأت على المجتمع الأولي الذي وجد في يوم ما . والذي أوصى به الرب وحمته التقاليد. والحل هي إزالة تلك البدع السياسية والثقافية والأخلاقية التي دخلت على النموذج الاجتماعي الأول والعريق والرجوع إلى ذلك المجتمع الأول أي النموذج الاجتماعي الأولي أي إعادة التاريخ إلى الوراء وعندها سيعم الخير والبركة والسعادة والأمن والسلام على البشر.. إن الفكر الثوري عند المتدينين هو الرجوع إلى المجتمع الإنساني الأول نحو العهود التاريخية الغابرة التي كان الناس يعيشون فيها حياة إنسانية هادئة بلا أزمات نفسية. إلى ذلك المجتمع الذي كان التعاضد والتآخي سائداً بين الناس ترى هل يمكن إعادة التاريخ بجانبيه المادي والروحي إلى الوراء ؟
هناك تيار ديني ثوري آخر (( التيار الصوفي )) وله أيضاً وجهة نظر فلسفية إن هذا التيار يعتمد على النشوة الصوفية الدينية والوحي الديني الصوفي والذي يعتقد بأنه يمكن أن يجد حلولاً لمشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وإن مفهوم المساواة من وجهة نظر التيار الصوفي. إن مفهوم المساواة تعني المساواة أمام الرب . بصرف النظر عن موقعه الطبقي.
كل الثقافة الفكرية خاضعة للتفكير الديني وتبقى مسيطرة وعلى أي محاكمة بصدد العالم والواقع الاجتماعي والتاريخي وكل الإبداعات التاريخية خاضعة للنشوة الصوفية إن الإنسان المتدين بكافة تياراته واتجاهاته يستند في فلسفته إلى علوم الدين . وما أنزل في الكتب المقدسة من أحكام ويعتبرها مقدسة غير قابلة للتغيير والتبديل والحذف والإهمال . صالحة لكل زمان ومكان غير خاضعة للشرط التاريخي.
ب- نقد الفلسفة البرجوازية للفلسفة الدينية وطرح البديل:
لقد اعتقد فلاسفة الطبقة البرجوازية أنه لا يمكن الصراع ضد الاضطهاد والاستبداد الإقطاعي و الصراع من أجل السلطة السياسية والاقتصادية بدون تغيير النظرة إلى العالم وهذا يعني التغيير في النظرة الفلسفية. فكان أمامهم إعادة النظر بمجمل منظومة ومبادئ ومناهج التفكير الأساسية التي تحدد موقف الإنسان من الواقع المحيط به . وهكذا شرعت في توجيه نقد شديد لكل التصورات الفلسفية للطبقة الإقطاعية. فكان أول جهد فكري قاموا به هو استبدال التعليم والنظرة الدينية. بالعقل والمنطق. إن السمة المميزة للفلسفة الجديدة التي طرحتها الفلسفة البرجوازية هي الثقة المطلقة بالعقل والمنطق وقالوا: إنه يمكن بواسطة التفكير العقلي وعلى أساس المنطق حل كافة ألغاز العالم .وسميت تلك الفلسفة بالمذهب العقلي وتفرع منه المذهب التجريبي وخلق صراع بينهما حول قضية المعرفة. وكان السؤال التالي إلى من يعود الدور المحدد لعملية المعرفة
أولاً 1- إلى التجربة الحسية 2- أم إلى التفكير العقلي ؟
وهكذا لعب المذهب العقلي دوراً كبيراً في صراعه ضد الفلسفة الدينية للطبقة الإقطاعية وبدأت في طرح بديل لمفهوم المساواة الدينية .
مفهوم مساواة الناس البرجوازية:
لقد استبدل مفهوم مساواة الناس (( أمام الرب)) الدينية بمفهوم مساواة الناس ((أمام القانون)) الوضعية العقلية. لقد وضع فلاسفة الطبقة البرجوازية تعميماً عقلياً للمجتمع واعتقدوا بأنه يمكن بناء المجتمع بموجب قوانين الميكانيك والمنطق الشكلي. وافترضوا أن المجتمع شأنه شأن الطبيعة يتألف من عناصر قليلة العدد ومتجانسة كيفياً والشبيه ببعضها البعض. ذرات اجتماعية والذين يتمتعون بحقوق متساوية وأبدية . وهكذا ارتفعت مساواة الناس أمام الرب إلى فكرة مساواة الناس الفطرية . وقد انطلقت الفلسفة البرجوازية من الفكرة القائلة بأن تطبيق الحرية المدنية يعتبر أساساً كافياً لبناء المجتمع المثالي وكانوا يفهمون هذه الحرية على أنها تحرر من السلطة الإقطاعية وتقسيماتها الاجتماعية. وهكذا برزت مساواة الناس أمام القانون. فكان برأيهم في حال إزالة الإرغام الخارجي وعندها يعطي الإنسان أقصى ما يمكن من المبادرة الفردية والحكمة. ويكشف عن مشاعره الاجتماعية والوطنية الصادقة والناضجة. وسوف ينسق عن وعي مصالحه وتصرفاته مع مصالح وتصرفات الناس الآخرين . أما ما يصدر عن الإنسان من أهداف مغرضة وأنانية وجشع وحسد وغيره هي نتيجة لانعدام الحرية على مدى فترة طويلة من الاضطهاد الإقطاعي والجهل وفقدان التعليم. وقالوا عن الدولة إن الدولة التي تتصرف فيها الأفراد أنفسهم عن وعي وطواعية بإقرار المساواة بينهم من الناحية الحقوقية سيخلق السلام والوئام والعدل بين الناس . لقد سلمت الفلسفة البرجوازية الناس بمقياس حقوقي يتيح استخدامه ضد الفلسفة الإقطاعية وإدانة امتيازاتها الفئوية واضطهادها الحقوقي لقسم كبير من الناس. لقد نادت الفلسفة البرجوازية بالمجتمع ذات التنظيم الحكيم وفي سبيل تحقيق هذا المجتمع ذو التنظيم الحكيم يجب إيقاظ السكان وإرغامه على أن يصبحوا حكيمين . وبغية إرغام الناس على العمل طبقاً لمطالب التنظيم الحكيم الاجتماعي. يجب أن يكون هناك مشروع ثقافة تنويرية. إن الفلسفة الاجتماعية البرجوازية التي نشأت كانت من حيث نزعتها فلسفة معادية للطبقة الإقطاعية وفلسفتها. لقد قام الفلاسفة بمهمة النقد الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية الإقطاعية التي انقضى عهدها ورفعوا المبدأ الأساسي والشامل للحياة الاجتماعية الحق الخاص. ودافعوا عنه واعتبروه الدرجة الأولى للممارسة البرجوازية واقرار تلك النظرة للعالم . واعتبرت هذا الحق الخاص من البديهيات وحقائق أبدية- وهكذا نرى أن الفلسفة البرجوازية كانت مصدراً للنضال ضد الفلسفة الإقطاعية ونظامها الاجتماعي برمته. وتحول الجماهير من السكون إلى الثورة ضد كل أشكال النظم الاجتماعية الإقطاعية وضد كل العادات والتقاليد الإقطاعية. لقد توحدت القوة الديمقراطية والمعادية للإقطاعية وفلسفتها الاجتماعية في إطار سمي (( الفئة الثالثة )) وكان المقصود بهذه الفئة (( الشعب . الأمة )) ومنها ظهرت الدولة القومية بشعاراتها الثلاثة(( المساواة والحرية والإخاء )) ونظامها السياسي الديمقراطي الليبرالي .
فلسفة الطبقة البروليتارية ونقدها للفلسفة البرجوازية وطرح البديل:
مفهوم المساواة والفلسفة الماركسية للطبقة البروليتارية:
لقد استبدلت الفلسفة الماركسية مفهوم المساواة البرجوازية أمام القانون ب(( المساواة الاجتماعية الاقتصادية)) وجاء نقدها للفلسفة البرجوازية على مرحلتين
1- مرحلة نقد المساواة البرجوازية أمام القانون
2- مرحلة نقد المساواة الشيوعية البدائية الطوباوية
1- مرحلة نقد الفلسفة البرجوازية :
لقد رفضت الفلسفة الماركسية مفهوم المساواة البرجوازية . ووجهت إليها نقداً شديداً وقالت: إن المساواة أمام القانون لم تلغ عدم مساواة الناس الاجتماعية الاقتصادية وإن المساواة أمام القانون البرجوازية لم تكن سوى بداية مرحلة جديدة في الصراع الطبقي وهكذا أشارت الفلسفة الماركسية إلى مفهوم الصراع الطبقي واعتبر أن كل التاريخ البشري هو عبارة عن صراع طبقي فكل التبدلات الاجتماعية التاريخية التي حدثت في الماضي لم تكن سوى نتيجة صراع طبقي وإن ما يحدد انقسام الناس وعدم المساواة أمام القانون هو الملكية الخاصة… ويعني ذلك إن ما يحدد مكان الإنسان في المجتمع الطبقي هو مقدار ما يملك من الملكية وليس مؤهلاته العلمية والفكرية إن إقرار الوثائق التشريعية واعتبار الملكية الخاصة مقدسة. يعني ذلك أنه أعطى الحق للإنسان في المستقبل أن يعيش على استغلال جهد الآخرين وهذا يعني عدم المساواة بين الناس . وإن تلك الوثائق التشريعية التي أبدعتها الفلسفة البرجوازية وحمتها فتحت الطريق أمام عدم مساواة الناس الاقتصادية وجوهرها خلق تناقضات هائلة في المجتمع. لقد بررت الفلسفة البرجوازية التناقض الطبقي وصراعه وتناحره إلى الإرادة الشريرة لبعض الأفراد. وإلى الناس الذين ليس لديهم قدراً كافياً من التنوير والأخلاق بغية التغاضي عن مصالحهم وممتلكاتهم في سبيل خير المجتمع وقد خلق لديهم وهم بأنه يمكن تخفيف هذا الصراع والتناحرات الطبقية عن طريق تربية الناس بواسطة الأخلاق الجديدة وعن طريق المحاكم والعقوبات لقد استطاعت الطبقة البرجوازية بفلسفتها أن تصفي أسلوب الإنتاج الإقطاعي وتنهي نظامه الاجتماعي. ولكن بنفس الوقت خلقت المقدمات وأسلوب إنتاج ونظام اجتماعي جديد وكلما تقدم هذا المجتمع وطريقة إنتاجه الرأسمالي برزت التناقضات بحدة وانهارت فلسفتهم التي كانت تتوهم بأن المجتمع ليس سوى ذرات متجانسة ومتساوية مع بعضها البعض من الناحية الحقوقية الشكلية وتابعت الفلسفة الماركسية نقدها للفلسفة البرجوازية.إن الفلسفة البرجوازية كانت ترى في تناقضات المجتمع خرق لقواعد العقل. ولكن المجتمع البرجوازي الذي ظهر على أنقاض المجتمع الإقطاعي هو أيضاً أظهر لنا تناقضات جديدة وقوى اجتماعية جديدة وتناقضات غير محلولة . إن الديناميكية الاجتماعية العفوية للمجتمع الجديد تتطور عبر التناقضات . إن نظرة فلاسفة التنوير كانت مثالية . لقد كانت فلسفتهم في المجتمع مبنية على الاتفاقيات الواعية والإرادية للناس ببواعث صادقة ومقولة. وألغت وجود أية قوانين موضوعية تاريخية اجتماعية مستقلة عن وعي وإرادة الناس. إن العامل المهم في وجهة نظر الفلسفة البرجوازية هو التركيز على الصراع السافر بين النظام الإقطاعي والأكثرية العظمى من السكان والتي كانت تسمى بالفئة الثالثة أي الشعب أو الأمة . لم تستطيع الفلسفة البرجوازية أن تكتشف النزاعات الجديدة وتترجمها إلى لغة المفاهيم. تلك النزاعات التي كانت مصدرها الملكية الخاصة. إن شعار المساواة أمام القانون كان يخفي وراءه قرعة البرجوازية والتي أساسها عدم المساواة الاقتصادية من حيث الملكية والعلاقة بين الجماعات الكبيرة فلم تستطيع أخذ وجهة نظر الناس الطبقية . وهذا ناتج من وجهة نظرتهم الفلسفية والتي تقول إن المجتمع كمجموعة من الأفراد الذين هم من طبقة إنسانية واحدة ولذا لا بد من أن يملكوا فطرياً حقوقاً طبيعية متساوية.
تلك هي المقدمات النقدية للفلسفة الماركسية ولظهورها ولتبدأ صراعاً جديداً سياسياً وأيديولوجيا والذي سيطر على النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستمر حتى نهاية القرن العشرين .
2- مرحلة نقد الفلسفة الشيوعية الطوباوية البدائية:
(( مساواة باببيف الشيوعية )) لقد قدمت فلسفة باببيف نقدها للفلسفة البرجوازية وبدأت بمفهوم المساواة- لقد قالت الباببفيه في نقدها.إن معالجة فلسفة التنوير لمسألة الملكية من الجانب الحقوقي بالدرجة الأولى.وإن إدخال حيازة الملكية ضمن الحقوق الطبيعية للإنسان والأبدية كان خطأ كبيراً. وجاء اعتراضهم على هذه الفلسفة بالقول: إن الملكية الخاصة تعتبر مصدراً للشر الاجتماعي وإن التاريخ كله ما هو إلا صراع بين الطبقات بين الغني والفقير..أي بين مالكي وسائل الإنتاج والمحرومين منها . فإذا سعت الفلسفة البرجوازية إلى التساوي التشريعي في مساواة الناس أمام القانون لا يكفي فلا بد من تساوي الناس الاقتصادي. وهكذا اتخذ اسم باببيف كرمز لهذه الفلسفة والمساواة الاقتصادية. واعتبرت نزعة ثورية. فولدت لدى باببيف نزعة ثورية يسارية متطرفة بضرورة إقامة مساواة مطلقة. وقام بتدبير مؤامرة أو انقلاب سياسي وأطلقت على هذه العملية(( مؤامرة المتكافئين)) وكان هدف الباببيفه إقامة جمهورية المتكافئين- تفترض التقسيم المتساوي التام للملكية واقترحت فلسفة باببيف صيغة جديدة للعقد الاجتماعي. ونقد مفهوم الحقوق الطبيعية للإنسان. وقالت الباببيفيه : إذا كان الناس متساوون من الطبيعة فإن هذه المساواة ينبغي أن تتحقق ليس فقط في المساواة أمام القانون. بل أيضاً في حال توزيع الملكية . وقد اعتبر الباببيفيون الملكية الخاصة نتيجة لجهل الناس وقلة عقولهم. وقالوا أيضاً إن المساواة التامة لا يمكن أن تتم بين الناس إلا بعد نقل الملكية إلى المجتمع إلى الشعب إلى المشاعية. إن المجتمع الذي حلم به الباببيفيون كان يجب أن يقام بواسطة الدولة بصورة قسرية. ولم يكن لأي إنسان حق التصرف بقوة العمل بصورة حرة. لأن كل شيء يتم تعيينه بواسطة الدولة ويشتغل بهذا العمل أو ذاك بواسطة الدولة. لقد نظر الباببيفيون للملكية على أنها مخلفات الماضي .
وأنها ظاهرة غير طبيعية ويجب القضاء عليها بواسطة العمل السياسي العنيف. لقد كان مخطط جمهورية المتكافئين الباببيفيين هي شيوعية الثكنات للمساواة الفظة تطبق بالقوة بسياسة العصا ولذلك اعتبرت الفلسفة الباببيفيه ونظامها الاقتصادي والسياسي ومفهومها للمساواة الاقتصادية طوباوية وخيالية لا يمكن تحقيقها في الواقع. وبقيت تعيش في عالم الأحلام. إن طوباوية باببيف الشيوعية البدائية تنفي تلك الآفاق الموضوعية التي ولدتها التطور للإنتاج الصناعي ولشروط التنظيم الاجتماعي للعمل. ونضج الطبقة العاملة وتلاحمها الثوري . ولذا كان لا بد من ظهور فلسفة ونظرية جديدة لهذه الطبقة في ظروف الإنتاج الصناعي المتطور وكان لا بد من انتقاد الشيوعية الباببيفيه البدائية. إلى جانب تصفية الحساب من سائر العقلية الميتافيزيقية . والفلسفة العقلية للتنوير البرجوازي. فكان ظهور ونشوء الفلسفة الماركسية. لقد ساهم ماركس وآنجلس هذان العبقريان بوضع أسس هذه الفلسفة والنظرية ومن بعدهما لينين. فكان أول وثيقة تاريخية لأعمالهما صدرت في عام 1848م وسمي بالبيان الشيوعي.
الفلسفة الماركسية اللنينية والنظرية الاشتراكية نشوءها وتطورها:
ككل شيء في التاريخ سواء أكان مادياً أو روحياً يولد من سابقها. فالفلسفة الإقطاعية ولدت من العبودية. والفلسفة البرجوازية ولدت من الإقطاعية. والفلسفة البروليتارية ولدت من البرجوازية. وهكذا ولدت الفلسفة الماركسية كسلاح للطبقة البروليتارية التي ولدها المجتمع الصناعي. لقد بدأت الفلسفة الماركسية بتوجيه النقد إلى الفلسفة التنويرية البرجوازية واليسارية المتطرفة. وقدمت نظراتها الفلسفية البديلة.
لقد قيمت الإنسان الذي هو صانع التاريخ وقالت: لقد رأت الفلسفة السابقة للماركسية أن الإنسان على أنه عام بدون الارتباط بأسلوب الإنتاج الملموس وبمرحلة من تطور الثقافة. وكانت آراءهم في إزالة التناقضات للاقتصاد الرأسمالي وعفوية السوق والتضاد بين الثراء والفقر- أن يكون الحل بالاتحاد الحر بين المنتجين أن يتفقوا لمرة واحدة وإلى الأبد. وأن ينشأ عقد اجتماعي جديد لتقسيم العمل . وكانت وجهة نظرهم تقول إن المشاكل الاقتصادية الأساسية تنحصر في النقود ويعتبرون من مخلفات عهد النظام الملكي وأن القيمة الزائدة لا تنشأ في مجال الاقتصاد الرأسمالي بل في تداول النقود فقط لهذا اعتقدوا أن عدم المساواة الاقتصادية بين الناس سببه التجار والمرابون والذين يجنون الأرباح من تناول البضائع. وهكذا استمرت الماركسية في توجيه نقدها للفلسفات السابقة. واعتبرت كل المخططات التي طرحتها الفلسفات السابقة مثالية غير علمية. لقد كان على ماركس وآنجلس إيجاد نظرية علمية بدلاً من ذلك. لذا كان عليهم أن يحلوا جملة مشاكل ونظرات للعالم الطبيعي والتاريخي والفكر وفق منهجين هما المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية. لقد أعادوا قراءة التاريخ بتعمق ووجدوا أن كل التاريخ البشري منذ أن تجاوز مرحلة المشاعة البدائية هو صراع طبقي. وأن الذي سبب هذا الصراع هو الملكية الخاصة. كون الملكية الخاصة ولدت الطبقات وبميلاد الطبقات خلقت التناقضات التناحرية وأدت إلى تفرقة واستغلال وحروب بين البشر فوضعوا أمامهم هدفاً استراتيجياً هو خلق مجتمع إنساني بدون طبقات يكون فيه الإنسان أكبر قيمة. وهذا الهدف الاستراتيجي للتنظيم الاجتماعي الجديد لا يمكن أن يوجد ما دام هناك ملكية خاصة والحل يكون بالإطاحة بالمجتمع الطبقي وإقامة مجتمع لا طبقي. الكل يعملون والكل يأكلون والكل يعيش على العمل الذي يقدمه للمجتمع وينال نصيبه بقدر ما يقدمه من عمل. لكل حسب جهده في المرحلة الأولى، ولكل حسب حاجته في المرحلة الأخيرة. وبذلك سيصل الإنسان إلى قمة العدالة والتطور الحضاري والإنساني حيث لا استغلال .
ونتيجة قراءة التاريخ بعمق توصلوا إلى القناعة من أن التاريخ يسير وفق قوانين موضوعية وليس بشكل عشوائي . هذه القوانين غير خاضعة لإرادة الإنسان ولمعرفة هذه القوانين انطلقوا من فكرة بسيطة هي أن الناس قبل أن يمارسوا السياسة والفلسفة والدين والفن أو أي نشاط روحي آخر. يجب عليهم أن يأكلوا ويلبسوا ويسكنوا . وفي سبيل تأمين هذه المتطلبات الحيوية عليهم أن يدخلوا في صراع مع الطبيعة لإنتاج هذه المتطلبات الحيوية. والإنتاج له قوة منتجة وسائل العمل والإنسان.ولدى عملية الإنتاج تنشأ علاقات بين الناس. وأهم هذه العلاقات علاقات الملكية. ويعيشون معاً في نظام اجتماعي معين ذو بناء تحتي وفوقي. وإن الذي يحدد طبيعة هذا التنظيم الاجتماعي هو البناء التحتي . والبناء التحتي عبارة عن تشكيلات اقتصادية اجتماعية متعاقبة لكل تشكيلة اقتصادية اجتماعية نظامها الفوقي الذي يلائمها. إن التغيير الذي يطرأ على التاريخ هو عبارة عن صراع طبقي بسبب علاقة الإنتاج القائمة على الملكية الخاصة ويحدث التغيير والتبديل في النظام الاجتماعي برمته عند عدم ملائمة علاقات الإنتاج مع القوة المنتجة . إنها عملية قانونية كانت التشكيلات المتعاقبة في السياق التاريخي للتشكيلة الاقتصادية المشاعية البدائية ثم تلتها التشكيلة العبودية ثم الإقطاعية ثم البرجوازية ثم الاشتراكية. وتكون المرحلة الاشتراكية خاتمة المطاف للصراع الطبقي لأن الملكية الخاصة تكون قد انتهت وتصبح من ذكريات الماضي. وعندها سيختفي البناء الفوقي برمته أي الدولة وسيتحول العمل إلى أكبر قيمة وسيتعود الناس على العمل ويصبح جزءاً من حياتهم. لقد قالت الماركسية إن التاريخ يسير إلى الأمام . ومستقبل الإنسان هو الانتقال إلى الاشتراكية وهي نتيجة حتمية. أما الجانب المعرفي في الماركسية اللنينية فكان جوابهم للسؤال الأبدي الأساسي للفلسفة وهو : هل العالم مادي أم روحي ؟ لقد وقفوا إلى صف الماديين ولكن بعد أن وضعوا كل تلك النظرات المادية السابقة تحت النقد بغية تخليصها من شوائب المثالية وهكذا قالوا أن العالم مادي وأن المادة لها الأولوية وأن الواقع الموضوعي منعكس في وعينا ولكن موجود بصورة مستقلة عنه. والمادة تملك مواصفات وخصائص ملازمة لها داخلياً ومحددة تماماً. ويمكن معرفة هذه الخصائص والمواصفات. وبذلك وقفوا موقفاً معاكساً للمثالية تماماً.
لقد انقسم المثاليون بين مثالية ذاتية وموضوعية. فلدى معالجة العلاقة بين الأفكار عن العالم وبين العالم الموضوعي. وبين وعي الذات وبين الموضوع الذي يدخل الذات في علاقة معه . اعترف المثاليون بالفكر والوعي القوة الأولية الوحيدة التي تشكل هذه العلاقة. والمثالية الذاتية تعتقد أن الأولى هو نشاط الوعي البشري أو عناصر من هذا النشاط.
وجواباً للسؤال . هل فكرنا قادر على معرفة العالم الواقعي؟ وأجابت الماركسية بنعم يمكن ذلك. وتكون بالمعالجة التفصيلية للتعقيدات الفعلية في عملية المعرفة وديالكتيكيتها وإن المنهج الديالكتيكي يقوم بالدور الحاسم للنشاط التحويلي التطبيقي أي الممارسة العملية وليس في الذاتية والإرادية واللاإرادية. وتقول: أن الممارسة تدفع بقوة إلى الأمام نحو معرفة قوانين التحويل الثوري وأن الممارسة سوف تنزل الضربة القاضية إن عاجلاً أو آجلاً بكافة مواعظ اللاإرادية والذاتية والإرادية والعفوية. لقد عللت الماركسية الفلسفة المادية نظرياً وطورت الفكرة الأساسية عن الخلق والمادة وقالت (( بعدم خلق الطبيعة )) وإن الطبيعة موجودة ومستقلة عن إرادة ورغبة الإنسان . إن ما نشاهد ونلمس ونحس من تغييرات وتبدلات وظواهر وأشياء يجب أن نبحث عن أسبابها في الطبيعة نفسها .وقالت الماركسية إن الطبيعة الموضوعية والمستقلة عن الوعي تمتلك قوامها وخواصها الداخلي الذي لا يمكن أن يلغيه أي تدخل خارق للطبيعة . ومن الناحية العملية ولكي تكون الطبيعة في خدمة الإنسان ولتأمين حاجات الإنسانية الضرورية لحياته يكون في دراسة هذا القوام الداخلي وخواصها وإمكانية معرفتها، ولا يمكن ممارسة أي نشاط يقوم بها الإنسان أو معدات يضعها أو أنظمة اجتماعية يقيمها أن تكون ناجحة، إذا لم تتناسب مع الخصائص الوضعية للعالم المادي نفسه ويمكن إجراء عملية المعرفة بإحدى طريقتين –1- عن طريق النشاط الفكري النظري المنظم العلمي –2-عن طريق الممارسة التجريبية والخبرة . وفي هذا المجال رأينا أن نبين للقارئ رأي مفكر عظيم وهو غولباخ في كتابه ((نظام الطبيعة ))والذي يعبر عن وجهة نظرته المادية. لقد كتب غولباخ في مقدمة كتابه وقال : (( إن كافة مصائب الإنسان تكمن جذورها في سعيه للخروج من حدود العالم الواقعي المعطى للإنسان من خلال خبرته وفي سعيه للتعامل مع العالم كما يحلو له)) . وفي إيجاد نقطة استناد لتصرفاته في القوة والكائنات الوهمية الخارجية للطبيعة وأردف يقول(( إن الطبيعة والتي لا وجود في خارجها لأية كائنات أو قوة خارقة للطبيعة مناصرة أو معادية للناس )). وخير ما قال (( إنه يستحيل إلغاء قوانين الطبيعة كما يستحيل جر الطبيعة إلى عمليات ما تتناقض مع قوانينها الخاصة والإنسان يعتبر قسم من الطبيعة ويوجد في صلة موضوعية معها، ويجب عليه الامتثال لقوانين الطبيعة باعتباره داخلاً في النظام الطبيعي العام. وإذا جرى تجاهل هذه القوانين أو عدم مراعاتها فإنها تعلن عن نفسها بصورة إرغامية وتتجلى بصورة عوائق في وجه نوايا الإنسان وتحبط هذه النوايا وتسبب المصائب والآلام )) . وأرشد غولباخ الإنسان كيف يجب عليه أن يتعامل مع الطبيعة وقال((إن مهمة الماديين تكمن في العمل لأن تنتصر الدراسة العلمية الصارمة للطبيعة وفي أن تنسجم نوايا الإنسان وأفكاره مع الخصائص الموضوعية للطبيعة نفسها وذلك يكون بواسطة أعمال البحث والتجربة المنظمة المحكمة)) وهكذا حتى الأسلوب المادي بالنظر إلى الإنسان في وحدته مع الطبيعة وأراد لنا أن نفهم الوعي البشري كجزء ونتيجة لتطور الطبيعة المادية بمجملها وإن القدرة على الوعي غير منفصلة عن التنظيم الطبيعي للإنسان وتتحدد به . والقدرة على الوعي والإحساس والتفكير مشترطة ببناء العضوية البشرية الحية وبناء مخه وأجهزة حواسه وقال الماديون أيضاً إنه ليس في روح الإنسان مثقال ذرة إلا ومشترط بأثيرات الخارجية للبيئة أو الحالة الداخلية للجسد. ووقف الماديون ضد الجمود العقائدي. وضد الخرافات والأوهام والآراء الروحية الباطلة . ووقفوا ضد الفكر التأملي. وقالوا إن الإنسان جزء من الطبيعة وإن وجوده وقدراته مشترطة بالتنظيم الطبيعي أي بناء الجسد والدماغ وأجهزة الحواس لدى الإنسان لقد طالبوا بتوفير ظروف للمعيشة تضمن صحة الإنسان وعمل عضويته بصورة طبيعية.
أما الفلسفة والنظريات المثالية كانت تنظر بازدراء إلى الحاجات الجسدية بوصفها حاجات دنيئة وحيوانية ووضعتها مناقضة لحاجات الروح والتطلعات الروحية وكانت تعتبر أن العذابات الجسدية على الأرض هي ضمان وشرط السعادة في الآخرة .
أما الماديون يفكرون بالعكس تماماً ويقولون :إن خير الإنسان وسعادته مستحيلان بدون تلبية حاجات الجسد الطبيعية والتي سموها بالحاجات الطبيعية الضرورية .
والمثالية توجه الإنسان نحو الكمال الذاتي والداخلي والوحي والأخلاقي الصرف. بينما الماديون أعطوا تبريراً للنضال الثوري من أجل إعادة بناء المجتمع وإقامة تنظيم للحياة الاجتماعية يساعد على التطور المتناسق جسدياً وروحياً وأخلاقياً للإنسان .
وتابعت الفلسفة الماركسية نقدها للماديين السابقين وقالت : فالماديون السابقون لظهور الماركسية لم يتمكنوا من تقديم تفسير مادي معلل نظرياً للأسباب والقوانين والآليات الموضوعية التي تعين التغييرات التاريخية لظروف الوجود الاجتماعي للناس وعن البيئة الاجتماعية الخارجية. فعندما كان يصل الأمر إلى التحليل للتطور التاريخي للوعي الاجتماعي والوجود الاجتماعي كان مبدأ تابعية الوعي الاجتماعي للوجود الاجتماعي يبقى في الظل . فكانوا يغيرون الانقلابات في نظرات الناس إلى العالم وسلوكهم إلى التغييرات الداخلية التلقائية في وجهات ونظر وأفكار الناس التي لا يمكن تفسيرها بأية أسباب موضوعية واعتبروا أن الأفكار تحكم العالم .
وأخيراً لنأتي في الإجابة عن سؤالنا الذي بدأناه.
لماذا يعيش إنساننا في أزمة نفسية وطريق الحل :
نعيش اليوم في عالم اختلطت الثقافات الروحية بعضها ببعض. وإن الفصل بين الثقافات بات أمراً مستحيلاً ولم يعد أمامنا سوى طريقين للتعايش.
1-إما الحوار الثقافي ومعها الأمن والسلام الاجتماعي لنتمكن من التفرغ نحو الانطلاق نحو المجتمع الصناعي .
2- وإما التناحر الثقافي ومعها العنف والحروب والتوجه نحو مزيد من التخلف والدمار .
ولكوننا بشر لا نستطيع أن نعيش إلا اجتماعياً، والحياة الاجتماعية تفرض علينا أن نتعامل مع بعضنا البعض بمختلف وجهات النظر فلسفياً وسياسياً وثقافياً الخ… ومع التطورات العالمية والثورة التقنية العلمية والإعلامية تحولت الكرة الأرضية بكاملها وأصبحت تحت البصر بالصورة والصوت واللون . ففي حياتنا الاجتماعية نحن مجبرون على أن نتبادل وجهات النظر في كل شيء فلا يمكن أن نرى شعباً أو أمة على سطح الكرة الأرضية إلا ويكون تكوينه مؤلف من ثقافة دينية وديمقراطية واشتراكية.
فالإنسان الديني له آراءه وفلسفته وكذلك الديمقراطي والاشتراكي. وكل واحد منا يختلط في يومه مع المتدين والديمقراطي والاشتراكي ويجري التجادل معهم.
وما نعيشه اليوم هو أن كل واحد من هؤلاء يحاول فرض آراءه وفلسفته على الآخر ، نجتمع ونفترق حاقدين كارهين لبعضنا البعض ونتيجة لذلك تحولت كل تناقضاتنا الاجتماعية إلى تناحريه ، ترى لماذا يحدث ذلك ؟.. يحدث ذلك لأن كل واحد يعتبر نفسه وفلسفته هي الحقيقة المطلقة . فإذا انتقى الإنسان المتدين بالديمقراطي والاشتراكي ولم يفهموه أو يؤيد آرائه الفلسفية اعتبرهم كفاراً وملحدين وتاركين لدين الله فيحل سفك دمهم . وإذا التقى الديمقراطي والاشتراكي بالإنسان المتدين ولم يقبل فلسفتهم اعتبروه رجعي متخلف يستحق السحق والموت. وهكذا تنقلب المواطنة المشتركة أو القومية أو أي رابطة اجتماعية أخرى إلى تناحرية. وهكذا ينتشر هذا التناحر ليسيطر على كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية الخ… وتصبح القاعدة الأخلاقية التي أبدعها جورج بوش الابن (( من لم يكن معي فهو ضدي)) هي السائدة، فإذا كان إنساننا واقع تحت الضغط النفسي من الحاجات المادية والتي يراها ولا يستطيع امتلاكها لأن العين بصيرة والجيب فارغة . وبالإضافة للضغط النفسي المعيشي. وهكذا أضيف ضغط نفسي آخر هو الضغط الفلسفي أيضاً مما زاد في أزمته النفسية أضعافاً مضاعفة…
إننا نعيش في العالم الثالث في مجتمعات تسود فيها حرب حقيقية خالية من الأمن والسلام الاجتماعي تماماً.
ففي كل يوم يأتيك الإنسان المتدين ويتلو عليك فلسفته ويقول لك لا خلاص لك سوى بما أتلو عليك وهي الطريق الوحيد للخلاص ويحذرك من أن تسمع فلسفة الكفار والملحدين الذين يسمون أنفسهم بالديمقراطيين أو الاشتراكيين.
ثم يأتيك الديمقراطي ويتلو عليك فلسفته ويقول لك لا خلاص لك سوى بما أتلو عليك وإياك أن تسمع فلسفة الآخرين المتخلفين الذين يسمون أنفسهم بالمتدينين وبالإرهابيين الذين يسمون أنفسهم بالاشتراكيين.
ثم يأتي دور الاشتراكي فيأتيك ويتلو عليك فلسفته ويقول لك لا خلاص لك سوى بما أتلو عليك وإياك أن تسمع رأي الجهلاء الجامدون والرجعيون الذين يسمون أنفسهم بالمتدينين وعملاء الإمبريالية والرأسمالية الذين يسمون أنفسهم بالديمقراطيين .
ولكن الثلاثة المتدين والديمقراطي والاشتراكي مواطنون في بلد واحد، وكلهم يعانون من التخلف السياسي والاقتصادي والحضاري وثلاثتهم بحاجة إلى مأكل وملبس ومسكن وحرية . فبدلاً من أن يجمعوا مواهبهم الإبداعية لينتجوا معاً مزيداً من المأكل والملبس والمسكن وممارسة حرياتهم . نراهم متناحرين ومتقاتلين ويزرعون الحقد والكره صباحاً ومساءاً ضد بعضهم البعض، ويزرعون الشوك وبالتالي سوف لا يحصدون سوى الشوك وهذا هو حالنا منذ خمسون عاماً فمنذ أن تخلصنا سياسياً من اللعنة والتي اسمها الاستعمار. فلا الإنسان الديني استطاع أن يوفر لنا بفلسفته المأكل والملبس والمسكن والحرية، ولا الإنسان الديمقراطي ولا الاشتراكي. وبات إنساننا يعيش في أزمة نفسية حادة من جراء هذه التناحرات الفلسفية ولم يجد أمامه أية بارقة أمل في الخلاص من هذه الضغوطات النفسية.
4ً- نقد طريق الحقيقة للفلسفات الدينية والديمقراطية والاشتراكية وطريق الحل:
كما قامت الفلسفة الدينية في بدايتها بنقد الفلسفة العبودية وكما قامت الفلسفة البرجوازية بنقد الفلسفة الدينية وكما نقدت الفلسفة الاشتراكية الفلسفة البرجوازية.
كذلك طريق الحقيقة لها الحق في تقديم نقدها. ونقد طريق الحقيقة يكون بطرح الأسئلة التالية مع بيان الآتي
لقد بينا كيف ظهرت الفلسفات الثلاثة في سياقها التاريخي وكيف قدمت كل واحدة نقدها للأخرى وطرحت حلولها لحل مشاكل الإنسان وهانحن الآن في بداية القرن الحادي والعشرين ونحن نعاني من أزمات نفسية حادة تهدد كل بنياننا الاجتماعي. إنما نراه اليوم الآتي:
1- لقد خرجت الفلسفة الدينية من معركة الصراع الفلسفي وخسرت موقعها السياسي والاقتصادي والثقافي وتحولت إلى ثقافة شعبية.
2- وخرجت الفلسفة الاشتراكية أيضاً من معركة الصراع الفلسفي وخسرت موقعها السياسي والاقتصادي والثقافي وتحولت هي أيضاً إلى ثقافة شعبية.
3- لقد ربحت الفلسفة البرجوازية المعركة وهاهي تحكم العالم وتطرح هيمنتها من خلال مفهوم ((العولمة)) وبدأت تشن هجومها الكاسح على الفلسفتين الدينية والاشتراكية وكل ثقافتهما لتحل محلها ثقافة الفلسفة البرجوازية (العولمة).
4- لقد صدرت فاتورة الذبح وفيها خمسة وعشرون شعباً ومنظمة وحزباً يؤمنون بالفلسفة الدينية والاشتراكية وسيذبح تباعاً لكل منه دوره وسيصفى دمهم لإطعام أفاعي حضارة الفلسفة البرجوازية العولمة.
ونقدنا يكون بموجب طرح الأسئلة التالية :
أ- ترى لماذا خسرت الفلسفة الدينية والاشتراكية معركتها ؟
بـ – ولماذا ربحت الفلسفة البرجوازية المعركة ؟
جـ -ما هي الحقيقة ؟
وأعتقد أن طريق الحقيقة قد بينت بما تراه مناسباً في سياقها التاريخي للفلسفات الثلاثة تاركاً الحكم والبحث عن الحقيقة للقارئ.ربما أن يأخذ درساً أو عبرة من التاريخ.
طريق الحقيقة وطرح البديل للحل :
أخي العربي والفارسي والتركي والكردي . إن الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء .
فإذا كان هناك يأس فهناك الأمل . وإذا كان هناك شر فهناك خير هناك تخلف وهناك تطور والحياة حركة وفي الحركة بركة . فإذا كنت مريضاً فابحث عن الدواء وإذا كنت يائساً فابحث عن الأمل وإذا كنت متخلفاً فابحث عن التطور.
وطريق الحقيقة تقول هناك طريق واحد للوصول إلى الحقيقة وهو التعبير:
التعبير هي البوصلة التي تجعل الإنسان في الوصول إلى الحقيقة في كل زمان ومكان.وتساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
إن الفرد أو الأمة أو الحزب أو الدولة التي يخنق التعبير هي أو هو سائرة نحو الفناء والدمار لا محالة. لا يمكن أن يكون هناك تطور أياً كان نوع هذا التطور سياسي اقتصادي اجتماعي وثقافي علمي حضاري بدون أن يكون هناك مناخ للتعبير ربما كان في الماضي ممكناً مع مجتمعات الحنطة والشعير . ولكن يصبح الأمر مستحيلاً مع المجتمعات الصناعية.
التعبير يخلق الراحة النفسية. بالتعبير يعرض الإنسان بما يؤمن به من أفكار وتصورات وآراء للتهوية كي يتأكد من حقيقتها .
التعبير يزرع شجرة الحرية وكلما كثر التعبير كبرت الشجرة ثم تعطي ثمارها .
التعبير نقيضها الكبت :
الكبت مرض خطير يخلق إنساناً ضعيف النفس مشلول الفكر مشلول العضلات وبالتالي يخلق شعباً خاملاً كسولاً بليداً ومتخلفاً ، الكبت يخلق إنساناً إرهابياً مجرماً لصاً منافقاً ، الكبت يضيع الحقيقة وتنقلب كل الأمور معكوسة .
لافيتو ضدّ التعبير: هناك خطأ فادح بالعالم الثالث بأكمله . فالناس الذين يتولون شؤون الثقافة والسياسة يعتبرون أنفسهم حكاماً ينوبون عن الناس في تقييم الخير والشر أو الجيد أو السيء والجميل والقبيح. فيسمحون لهذا ويمنعون ذاك عن التعبير لو عرف هؤلاء مدى خطورة عملهم هذا على المجتمع على المدى البعيد لما فعلوا ذلك.إن تصنيف التعبير بالسيء والجيد والنافع والضار والجميل والقبيح هو من حق الجمهور ، فليكن التعبير حراً للسيء والجيد والصادق والكاذب وعلى الناس أن يحكموا ويختاروا .
أخي الإنسان لا تكن مغروراً وتعتقد من أنك تملك الحقيقة فتجر على نفسك ومن معك إلى التهلكة ((التعبير هو طريق الخلاص))
بالتعبير نطهر أنفسنا، وبالتعبير نبني عقولنا، ونحب بعضنا، ونبني وطننا، ونزيل التخلف من واقعنا ، وبالتعبير نبني الإنسان ، لا يبنى الإنسان بالخطابات والتوجيهات والمواعظ ولا بالقرارات السياسية والشعارات ولا في البرلمانات ولا في الأحزاب . فبقدر ما نكثر من منابر التعبير نتقدم أكثر .
وطريق الحقيقة تعبر عن رأيها في طريق الحل وتقول : إن التاريخ قد أعطى كامل الفرصه والحق للفلسفة الدينية والديمقراطية والاشتراكية لأن تقدم حلولها لمشاكل الإنسانية واليوم نشعر بأن كل مستقبل الإنسان والحيوان والنبات والمياه والهواء والطبيعة برمتها في خطر شديد لقد بات تباشير طوفان نوح يلوح في الأفق . لم يعد هناك مجال لإعطاء التاريخ فرصة أخرى للفلسفات الثلاثة لأن تجرب حظها لحل مشاكل الإنسانية، والآن جاء دور فلسفة أخرى هي:
فلسفة حقوق الإنسان وسياسة غصن الزيتون : ذلك هو الميل التاريخي وكل من يحاول التمسك بالفلسفات السابقة ومحاولة وقف التاريخ أو إرجاعه إلى الوراء سيجر على نفسه الويلات ، إن فلسفة حقوق الإنسان وسياسة غصن الزيتون هي طريق الخلاص من طوفان نوح جديد. وكل من لا يدرك أهمية هذه الفلسفة ونهجها ونشرها ويعمل بها تنتظره أيام صعبة .
ترى هل نفهم التاريخ وننقذ أنفسنا وطبيعتنا الجميلة من الهلاك .
أخي العربي والفارسي والتركي والكردي لا تعاند حكم التاريخ وميوله وقوانينه فيحكم عليكم بالفناء، انظروا ما يدور حولكم وماذا حصل بالذين حاولوا معاندة التاريخ.
5ً- القضية الكردية ودورها في حل الأزمة النفسية لأبناء الأمم الأربعة الفارسية والعربية والتركية والكردية:
شعارها الحرية للكردي والديمقراطية للفارسي والعربي والتركي
أربعون مليون كردي بشعبه ووطنه تم توزيعه من قبل فلاسفة سايكس بيكو بين أمم ثلاث العربية والفارسية والتركية وأعتقد أن هذا التوزيع لم يكن حباً في سواد عيون العربي والفارسي والتركي ، لقد انقضى قرن كامل وحل قرن آخر لم تستطع أية أمة من الأمم الثلاثة أن تجد حلاً لهذه القضية لو قدر لنا أن نحسب بالآلات الحاسبة الإلكترونية مقدار المال والجهد الذي صرفته الأمم الثلاثة وما جهز لها من قوات خلال قرن كامل لجعل الكردي عربياً وفارسياً وتركياً تبين لنا لماذا يعيش الإنسان العربي والفارسي والتركي والكردي في أزمة نفسية حادة .لقد تم إفراغ الإنسان العربي والفارسي والتركي من جوهره الإنساني والديمقراطي تماماً وبنينا إنساناً قاسياً لا يؤمن سوى بالعنف والحقيقة المطلقة .
لقد تم تدريب الإنسان العربي والفارسي والتركي على قتل الكردي وتدمير قراه وانتهاك عرضه وسلب أمواله ومنعه من التكلم بلغته ، كل هذه الأعمال مخالف لمبادئ الدين الإسلامي الذي يجمعنا والذي نمارس طقوسه وعباداته في كل يوم ، ومخالف لكل التاريخ الذي يربطنا ، ومخالف لكل المواثيق والمبادئ الدولية ، ومخالف لقوانين الطبيعة إن كل إنسان له عقل ويلم ولو قراءة بسيطة بالتاريخ ، يرى أن إنساننا الذي عاش ذليلاً طوال قرن كامل مع أزماته النفسية بات ضعيف النفس وهزيل الجسم وشارد الفكر ولا يملك من وسائل القوة الدفاعية شيئاً ُوبعد صدور فاتورة الذبح لخمس وعشرون شعباً بتهمة الإرهاب، هاهي طبول الحرب تقرع وبعنف.
فبالإضافة لما يعانيه إنساننا العربي والفارسي والتركي والكردي من أزمات نفسية معيشية وحاجاتية وأخلاقية وفلسفية وهاهي طبول الحرب تضيف أزمة نفسية أخرى إلى نفسه، ولم يعد هناك وقت كاف للتفكير ، لقد بات إنساننا في انتظار ظهور طائرات الشبح وصواريخ “كروز وب 52” لتدمير ما بنيناه . ولتتحول شعوبنا إلى شعوب مهاجرة ولتسكن تحت الخيام. لقد أوصتنا ثقافتنا الدينية بأن نعد العدة وأسباب القوة ولا نرمي أنفسنا إلى التهلكة . ولكن أين القوة ؟ والمصيبة الأكبر أننا مازلنا نحلم بإمكانية العيش على الطريقة القديمة ونجابه باستراتيجياتنا التي عفا عليها الدهر .
عالم يتغير ، ونسلك سلوك النعامة .
لقد قال اليوغسلاف بإمكانهم أن يعيشوا على الطريقة القديمة، وأعتقد أن النتيجة معروفة للجميع وكذلك إندونيسيا والعراق والجزائر والسودان وأفغانستان.
وأخيراً جاء دور الشرق الأوسط .
لقد قلت دائماً وأبداً إن ما يجمعنا مع العربي والفارسي والتركي والكردي من أواصر وعلاقات تاريخية لا يمكن لأحد أن ينفصل عن الأخر وإن قوتنا في اتحادنا. ولا يمكن أن تكون هناك قوة مالم يعترف بحق الكردي في الحرية في وطنه كردستان ولابد من إنشاء علاقة سياسية معينة مع الكردي بدلاً من إضاعة الوقت والجهد والمال في إنكار الكردي وتدمير قراه واستخدام الغازات الكيماوية في سبيل جعله عربياً أو فارسياً أو تركياً.
قلت إن دوحة الحرية التي تجمعنا هو طريق الخلاص للكل وتجنب شعوبنا الويلات والخراب . إن التناحرات المدمرة تسيطر على شعوبنا ولا بد من أن تكون النتيجة خسارة الكل. إن القوة الوحيدة التي تجمعنا هي اتحاد العربي والفارسي والتركي والكردي لنشكل بهذا الاتحاد عمقاً استراتيجياً جغرافياً واقتصادياً وبشرياً وعسكرياً وهو الضمان الوحيد للخلاص والضمان لتطورنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتالي خلاص إنساننا من كافة أزماته النفسية .
وإلى اللقاء في الحلقة رقم /10/ من طريق الحقيقة
حلب في محمد تومة
28/2/2002 أبو إلياس
أبو إلياس – طريق الحقيقة رقم 31
طريق الحقيقة رقم 31 موضوع الحلقة: هل امريكا هي القطب الوحيد الغير منازع لمئة سنة قادمة. ول…